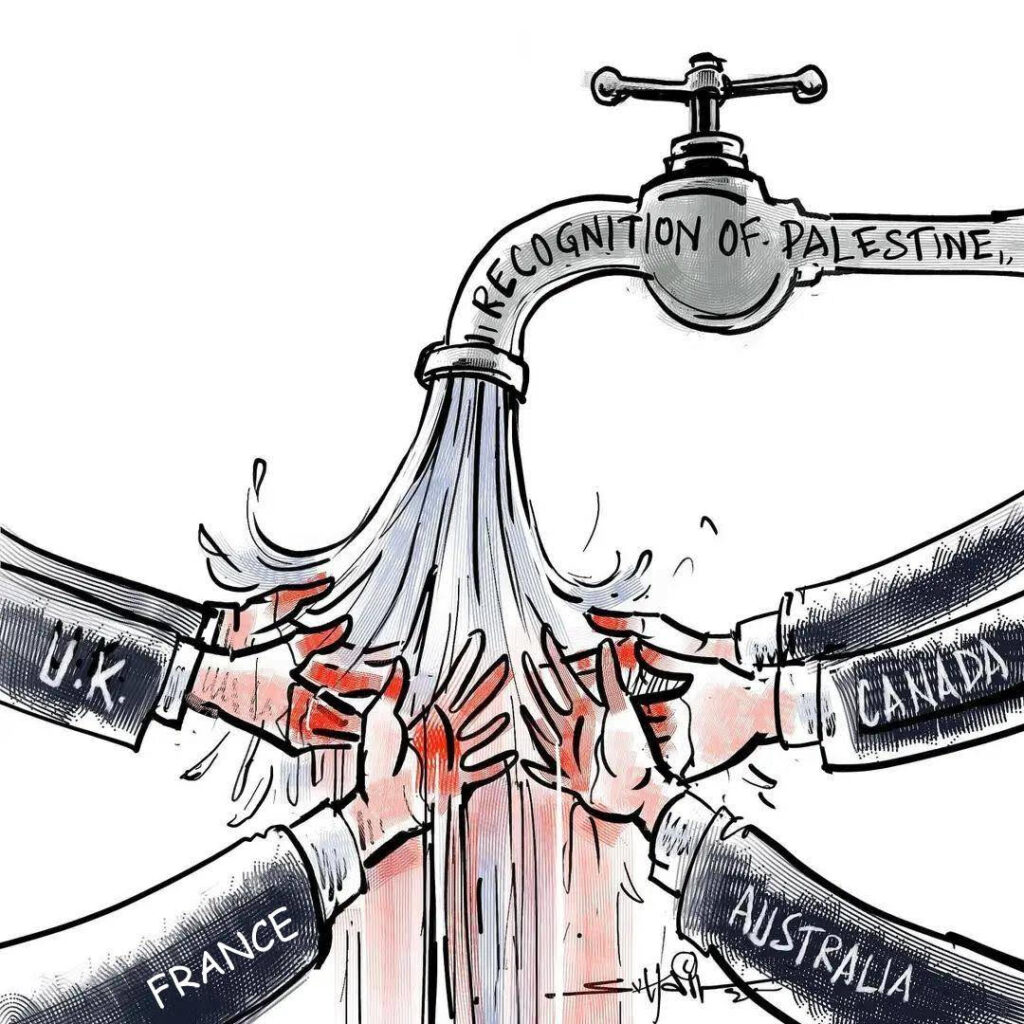جودة لـ “شبابيك” : لا نحب المخيم لكنه تذكرتنا للعودة
الأحد 13/05/2018صور ـ شبابيك ـ إيمان جمال الرفاعي
“غزة اليتيمة” وذلك الحزن الموغل في تفاصيلها “برائحة السجائر ونسمة الهواء، وضحكات الاطفال” أمامها البحر وخلفها وجع البلاد وإحدى عشر عاماً من الموت المؤجل وسنوات الإنقسام، لكنها العصيّة على الإنكسار، مدينة الحب والحُلم تُصر أن تبني جسر العبور نحو الحياة، تستيقظ كل صباح لتمسك بيدنا بعد أن خارت قوانا وتساعدنا على النهوض من جديد، تحضر لنا قهوة الصباح وتغني معنا “أُغنيات للأمل والفرح” هذه المدينة لها حضورها الطاغي لا تقبل إلا أن تتصدر نشرات الاخبار والصحف اليومية بجنونها وعظمتها وقدرتها على الإبداع، تنهض من بين أنقاضها لترسل رسائلها “إلى بغداد” لماذا بغداد ربما لأنها الجميلة، أو ربما لأنها عشقنا الأبدي الذي لم يمت، أو ربما لأنها شقيقة فلسطين بالألم، ربما وربما، لا أحد يعلم الجواب سوى مبدع من البلاد.
شبابيك إلتقى الكاتب محمود جودة، صاحب الرسائل، وحاورته حول معانيها ومحتواها.
- كيف استطاع محمود جودة تطويع عوالم المخيم وتحويلها الى نصوص أدبية؟
ـ مَن لم يولد في المخيم، يستوحش العيش فيه، وأنا من هؤلاء الناس الذين لا يستطيبون بسهولة العيش خارجه، لا أستطيع، أحن لكل شيء فيه، للناس الذين يشعرون بالملل، والسوق، وأكياس النايلون الطائرة، والصغار”السَّفلة” المزعجين، العباقرة، وشوارعه الضيقة التي سرنا فيها طويلا نحن والأصدقاء وإسترحنا على مصاطبها التي كانت منصات للنقاش والتفكير والتفسير، وفي النهاية نصل إلى لعن المخيم!
لا شك أن للمخيم الفضل في تشكيل حالة الرفض داخل الكاتب وصاحب الرأي، وهذا يأتي في البداية من حالة التذمر التي تُخلق عندما يتعرّف (إبن المخيم) على العوالم التي تحيط به، فيبدأ بلعن الكل، لأن الكل هذا هو سبب بؤسه.
نحن كلاجئين لا نحب المخيم، فهو كيان غير صالح للسكن، ولم يعد كما نشأ، فقد إمتلأ بالناس، والمشاكل والمستنقعات المائية، التي تسمى زورًا صرف صحي، وبيوت عبارة عن صناديق لا تدخلها الشمس. المخيم ليس بذلك الشيء الذي يدعو للفخر، نحن لا نحبه لأجله، بل هو تذكرتنا للسفر الحتمي، لذلك نحب تحدينا، وعدم خجلنا من العيش فيه، نحب أبطالنا الذين علقنا صورهم على حيطان (سنتر المؤن)، ومدارس الوكالة، وأبواب الدكاكين، هؤلاء الذين ذهبوا من أجل الحفاظ على تذكَرة العودة.
حدثت ابنتي بغداد في كتابها الذي أسميته “رسائل إلى بغداد” عن المخيم فقلت لها: “لن تسمعي عن البلاد المسروقة إلا في المخيم. أما المخيم ككيان، وكواقع مفروض علينا فنحن نكرهه، ونتمسك برمزيته، فبقاء المخيم يعني حتمية العودة، الحفاظ على اللاجىء يعني الحفاظ على الجذور، لأن الشجرة بدون جذورها لا تحيا، ولا تثبت في الأرض، لذلك المخيم هو الوتد والرسن، الذي يجب أن نتمسك به؛ حتى نستعيد الجَمل المسروق. بغداد، المخيم هو الهزيمة المتكررة، التي تذكرنا دومًا بضرورة الحركة والفداء، هو الشعلة التي تذكرنا بحقنا، لا دفء في المخيم، ولا نصر، ولا استقرار أبدي، كل ما في الأمر أنّ المخيم هو أول البوابات التي ستخرجين منها عائدة إلى بلادنا السليبة.”
- كيف انطلقت فكرة كتاب “غزة اليتيمة” وما هي الرسالة التي أراد إيصالها للقراء؟
ـ تدور أحداث كتاب “غزة اليتيمة” خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سنة 2014، الذي خلف آلاف الضحايا ما بين قتيل وجريح ومُعاق. كما يحوي الكتاب مجموعةً من المشاهد الإنسانية التي توثق حياة الناس في تلك الفترة، حاولت أن أصور بالكلمات ما لم تستطع الكاميراتُ توثيقه، وأكتبه كي يصل إلى مسامع الجميع،رويكون شاهداً على حقبةٍ زمنيةٍ من أشدّ وأخطر ما عانته فلسطين، وخصوصاً قطاع غزة على مدى تاريخه الطويل، على صعيد الحصار والحروب المتواصلة التي تُشن عليه، حيث تطغى الدماء على المشهد العام، ولا يلتفت الكثيرون إلى ما يحدث من مواقفَ إنسانيةٍ، تستحق أن يُكتب عنها.
جُمعت اليومياتُ المدونة في الكتاب من أفواه الناس الذين عايشوا التجربة القاسية إبان فترة العدوان، ولاسيّما أنني كنت شاهداً على العديد منها، التي حدثت أمامي طوال أيام العدوان وتشريد الناس إلى مراكز الإيواء.
“غزة اليتيمة” الكتاب الذي تحدث عن أهل غزة، أهلها العاديين جدًا، الطيّبين الذين يحبون ويدخنون الحشيش ويضحكون، ويرفضون الموت، أهلها الذين يريد البعض تصويرهم على أنهم خارقين للعادة، وأبطال جاهزون دومًا للموت، أنا حاولت أن أقول في ذلك الكتاب أن غزة تريد الحياة في سبيل الله والحب والجمال، وليس الموت في سبيل أحد، ولا من أجل أحد.
- كيف استطاع محمود تطويع أدبه لخدمة قضيته؟
ـ هذا السؤال ما زالت إجابته خلافية، هناك من يقول أن الأدب هو فعل من أجل الإمتاع وليس له قضية، وأنا أختلف كثيرًا مع هذا الرأي، يجب أن يكون الأدب ممتعًا، ولكن من قال أن الإمتاع لا يحدث عندما يحمل الأدب قضية، الأديب هو لسان حال البلاد، وهو الأمين المستأمن على حاضره الذي سيدونه من أجل أن يصبح تاريخا للأجيال القادمة، أما عن تطويع الأدب لخدمة القضية، أرى أن أي شيء يتم تطويعه، هو شيء مؤقت التأثير، وأن الأدب بالدرجة الأولى هو إبن البيئة، وما نحن إلا مترجمين لما يحدث، لأن القلم الذي بيد الكاتب؛ ما هو إلا أداة لربط القلوب، والشعوب والبلاد التي تقطعت بالأسلاك الشائكة، ونقاط العبور، والأقلام المأجورة. كُثر هم من كتبوا، وحققوا الشُهرة، وسرعان ما إندثروا وراحت أعمالهم دون أي تأثير أو فائدة، لأنها لم تكن تحمل في طياتها عوامل خلودها، ألا وهي القضيّة، لذا وجب على الكاتب أن يصفي كتابته من شوائب الضعف، والخطأ، وأن يكون لديه ما يرويه عن نفسه وبيئته، وتجربته قبل أن يتصدّر للكتابة عن أي شيء آخر.
- كيف يرى محمود واقع الأدب في ظل حالة الانقسام الفلسطيني؟
ـ سؤال مؤلم، ولكي أجيب عليه يجب أن أكون صريحًا جدًا .. الواقع يا صديقتي مقرف وسخيف ووقح في آنٍ معًا، لقد ضرب الانقسام الحالة الأدبية في مقتل، فساكن غزة يكتب عنها، وساكن الضفة يكتب عنها، وخذي هذا مقياس على كل شيء، لقد لعن الإنقسام أساسنا جميعًا، وبتنا ككتاب نتبع للجغرافيا التي نسكن فيها، ونعاقب بها وبإسمها.
- من هي بغداد، ولماذا خصصت رسائلك إليها، ولماذا بغداد بالذات؟
ـ بغداد هو اسم ابنتي البكر، أسميناها بغداد كي يبقى النخّل شامخاً، كي تبقى الشوارع العتيقة، والذكريات، أسميناها بغداد؛ كي نشعر بالغنى، فإسمها وحده يكفي كي ترفع الرأس عاليًا وتقول: أنا بغداد، أنا نخلةٌ عربيةٌ يعلو رأسها رغم الخوف النائم في جنبات البيوت، أنا بغداد وأصلي عربي.
يقول ابرويز لكاتبه “اجمع الكثير مما تُريد في القليل مما تقول”، وأنا حاولت فعل ذلك في هذه الرسائل التي أوجهها من خلال إبنتي بغداد، إلى الأجيال القادمة، فبغداد حاضرة بروحها وكيانها كله، وبمجازها الذي أخاطب به كل أبناء جيلها.
هذه ليست مجرد رسائل شخصية، بقدر ما هي عملية توضيح وشرح لمجموعة من القيم المجتمعية، والأحداث السياسية، بلغة أدبية، لأنني مؤمن أشد الإيمان؛ أنّ الأدب أصدق المصادر للدراسات النفسية، والإجتماعية، والتاريخية، وما يحيط بالإنسان مِن أحداث كثيرة، وأنّ للكاتب رسالة يؤديها إلى العالم، وهي فهمه العميق لما يدور حوله من أحداث وتطورات، ولطالما كان الأديب العين التي تُخبر عن قادم الأيام، ولكن أين الذين يقرأون؟
إجتهدت في تدوين هذا الرسائل أيّما اجتهاد، لأكون مُحقا فيما كتبت، ولا أدري أن كان القارئ يراني أحسنت في إخراج هذا الكتاب، قد يكون ذلك، وقد لا يكون، ولكن ما لا شك فيه أني رفعت عن كاهلي عبئًا ثقيلا، وأمانة كبيرة، وجب عليّ تقديمها كما عاصرتُها للأجيال القادمة، كي تعرف عن قرب ما حدث بلسان الأدب، لا بلسان الصحافة والسياسة، وما أتعسني لو حظيت بالثناء من غير أهل الحكمة والأدب، وأولئك الذين اعتصرت قلوبهم صروف الحياة.
- هل يتبنى أحد أدب محمود جودة، ولماذا لا يجد الكاتب الفلسطيني تشجيعا كافيا وتبنيا من قبل الجهات الرسمية؟
ـ الناس .. الناس هم من يبنون الأدب، يكفي أن تشعر ككاتب أنك تعبر عمّا يجول في خواطر الناس، وأن تكون لسان حالهم، الجهات الرسمية تتبنى أدبها، وأدب من يتحدث بإسمها، إذا تبنى أحد أدب محمود جودة أو غيره، وقتها عليك أن تكفي عن قراءة أدبه، لأنه سيكون لسان حال من تبناه.
- ما هي أكثر المشاهد الذي تجذبك إلى غزة والأخرى التي تزعجك؟
ـ غزة هي المدينة التي لا تعرف كيف تموت، فتحيا إلى الأبد، غزة التي حاول البَعض إخفاءها، غزة الحلوة الغنية الرشيقة، التي يُصدرونها على أنها مادة للجهلِ، والفقرِ والتسوّل، غزة التي لفوها بشاش الخديعة؛ ليسرقوا أعمار أهلها وهم مخدرون بزيف البطولة والصمود، غزة التي بُحت، وتبكي، وتغني، غزة المدينة التي استبدلوا لسانها، بالناطقين بأسماء الفصائل، غزة التي أشهروا في وجه أهلها سيف العادات والتقاليد؛ كي يخنقوها، فهم لا يستفيدون منها إلا مريضة، جاهلة، تبيع كرامتها على أعتاب بيوت الحكام، هذه المدينة الصغيرة مساحة، الكبيرة في كل شيء، هذه المدينة تُصر على إدهاشك في كل المناسبات، فدومًا تكون مُستعدّة، ولا تقبل إلا أن تُقابلك بالوجه الذي يليق بها، ففي التضحية تكون في المقدمة، وفي المقاومة تكون في رأس الحربة، وفي الأفراح تتجمّل بكل ما أوتيت من سعادة؛ لتليق بأهلها الذين لولا لعنة الجغرافيا، لكانوا أكثر من مجردِ أعدادٍ على الخارطة.
غزة كلها تجذب النظر، فلا تزال المدينة كاملة الأوصاف، مُزينة بشبابها وشيبها ونسائها اللواتي يُشبهن مآذن المساجد في وقوفهن المُقدس، وصباحهن الذي يفرض على الرائين الحب والأدب، فلو قُدِّر لهذه المدينة السلام، لناطحت بعلمها وجمالها أفضل حواضر العالم، غزة التي لا تستطيع الموت، تبقى تحافظ على ما في قلبها من حياة، رغم ما يعتريها من وجع، غزة المدينة التي تُخفي دمعتها وتتحامل على جرحها، وتتجمل بالفرح؛ لأنها على يقين بأن الفرح والغناء أبقى من الدموع وإن طال الأنين. أنا لا أقلق على غزة، ما دامت النساء فيها رغم الوجع النابت في الأنحاء الغناء، والضحك، رسم الكحل على سماء الجفون.