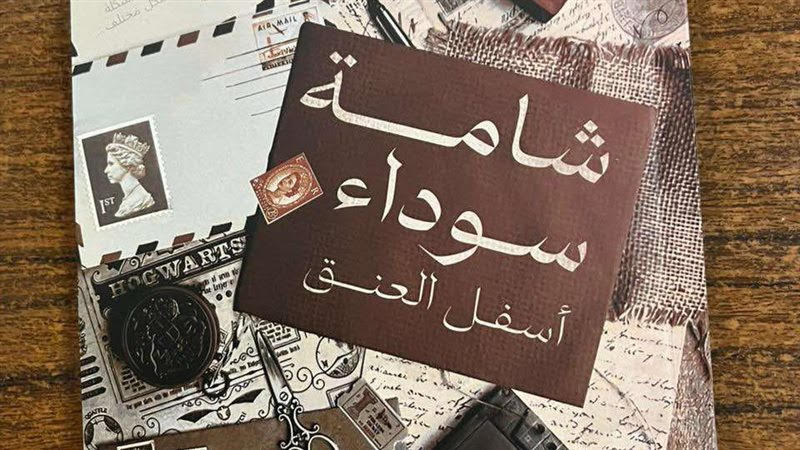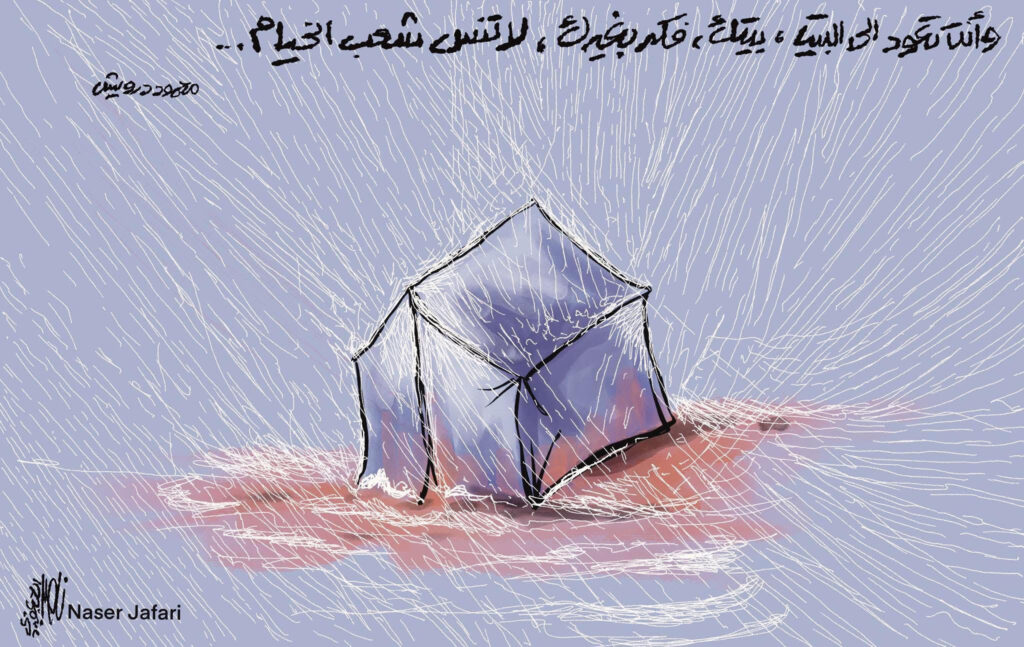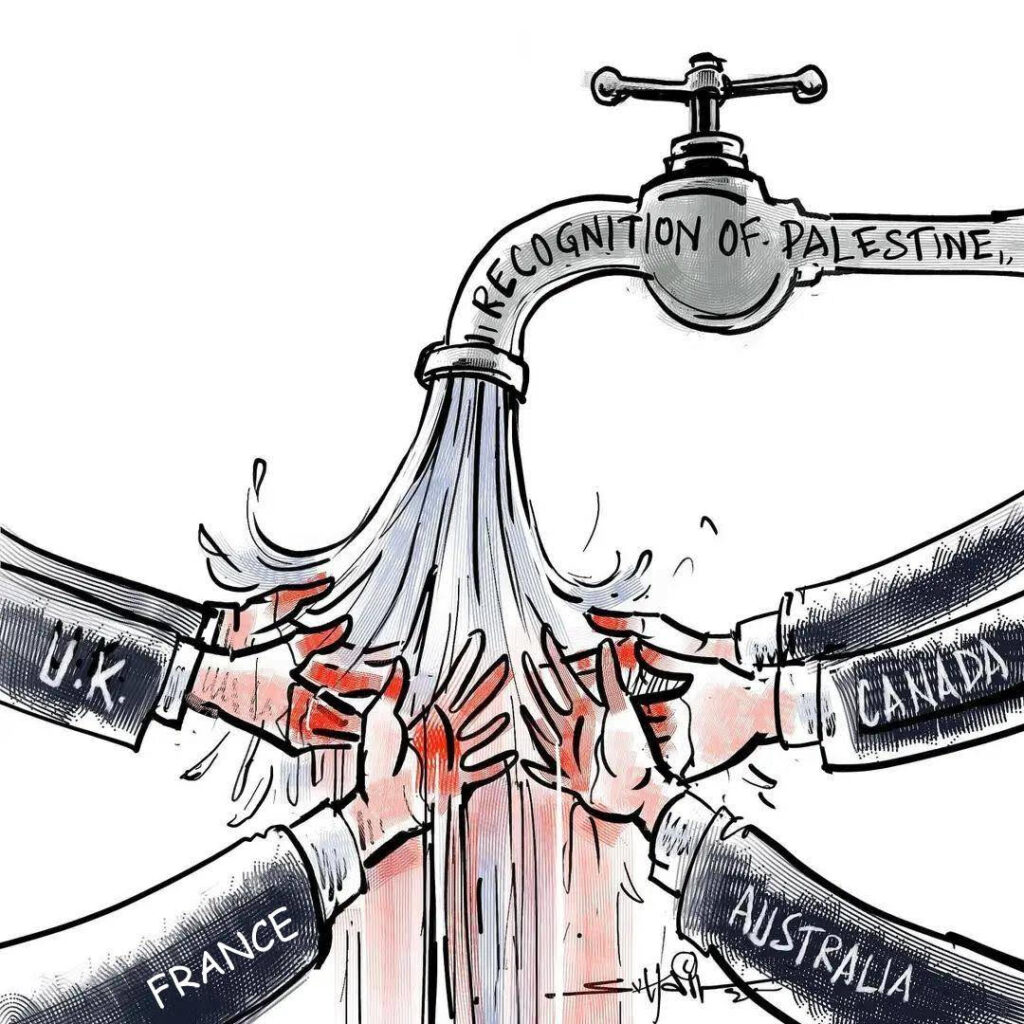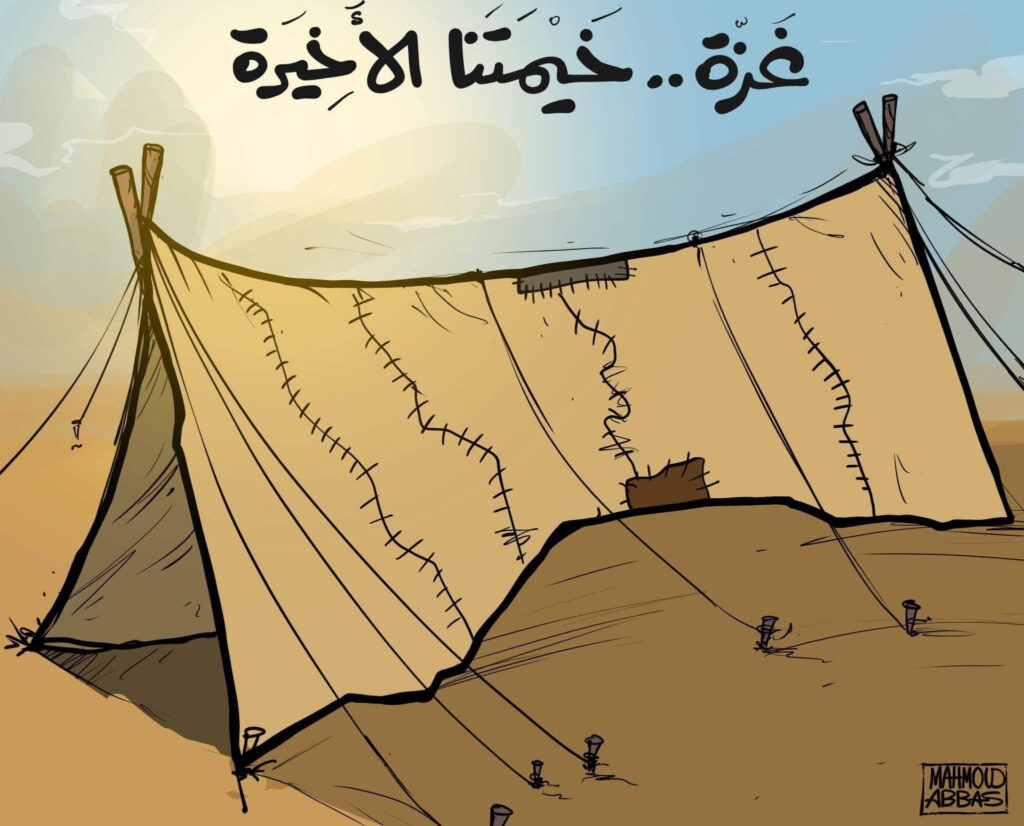“شامة سوداء أسفل العنق” رواية الفلسطيني جهاد الرنتيسي: زحزحة الثبات في أشكال الشتات والثورة
الأحد 26/01/2025- عادل ضرغام
في راوية “شامة سوداء أسفل العنق” يقدم الكاتب الفلسطيني جهاد الرنتيسي استكمالا لثلاثية الشتات الفلسطيني، وحركة تمركزهم بين مدن عربية عديدة، ونشاط بعضهم السري، خاصة في مدينة الكويت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، ويركز على خيباتهم وانشقاقاتهم، وعلى علاقاتهم الخاصة بأرض المأوى، وتصوّرهم الخاص لفكرة الوطن، وارتباطهم بهويتهم. هناك مساحات متداخلة بين هذه الرواية وروايتين سابقتين: “بقابا رغوة”، و”خبايا الرماد”، فهناك شخصيات موجودة في الروايات الثلاث، وهناك- أيضا- في الكتابة السردية في هذه الرواية اعتماد على مؤسس سابق، فيما يخص الأفكار المعرفية، وأشكال الشتات، ومواقف الشخصيات على تنوّعها من الثورة والمقاومة.
ففي الجزء الأخير لم يعد بحاجة ماسة للكشف عن شخصياته من خلال الأوصاف المسدلة عليها، لأن لها تشكيلا سابقا، وإن لم يكن كاملا. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار هذه الرواية جزءا من ثلاثية ترتبط بالشتات الفلسطيني، يتمّ تقليبه في كل رواية على حدة، وبراو مختلف، ووجهة نظر مختلفة نابعة من التغييرات الخاصة بالوعي بفهم المقاومة وأبطالها، في تعرية بعضهم من القداسة، وتقديمهم في سياق موضوعي إنساني، فالقادة في هذه الرواية لهم أخطاؤهم وانحيازاتهم. يكشف عن هذا التوجه في جزء كبير من الرواية، الاستخدام اللافت للأسماء بشكل واضح، سواء أكانت هذه الأسماء سياسية أو ثقافية.
يطالع القارئ لهذه الرواية من خلال الآلية السردية الفاعلة المكوّنة لبنيتها- وهي تيار الوعي- أسماء فلسطينية لها دور معروف، مثل نمر صالح، ورشاد الناجي، وسعد الخبايا، وباسم سرحان، وماجد أبو شرار، وهاني جوهرية، وإلياس شوفاني، ومحمود درويش، وأسماء مصرية مثل فؤاد زكريا، لأن البطل طالب يدرس الفلسفة بجامعة الكويت، وهناك حضور لغسان كنفاني وروايته “رجال في الشمس”، وكأننا أمام قراءة جديدة للحالة الفلسطينية تضاف إلى قراءات سابقة، قراءة أوجبتها السياقات الحضارية الجديدة. فذكر هذه الأسماء بعيدا عن الترميز أو الإشارة الخافتة- وبعضها يشير إلى انشقاقات خاصة داخل فصيل المقاومة الأساسي- يستدعي إلى ذهن القارئ فكرة المساءلة المستمرة، والجنوح نحو التعرية، وتقديمها في سمت إنساني بعيدا عن القداسة المعهودة، في ارتباط بعضها بمصالح خاصة ضيقة، بعيدا عن فكرة المقاومة بأفقها المثالي.
بنية الرواية وزحزحة الثبات
يجد القارئ نفسه أمام بنية روائية شديدة التعقيد، فليس هناك سرد متنام منظّم، وليس هناك استجلاء لطبيعة الشخصيات، أو تفسير لدوافعها أو حركتها أو توجهاتها، ولن يستطيع أن يلمّ بجزئيات الحكاية – إذا افترضنا أن هناك حكاية – إلا بالتركيز والإنصات الشديدين. تتشكل الرواية وفق آلية سردية أساسية فاعلة، هي آلية تيار الوعي، من خلال راو غائب يقارب البطل في انفتاحه الذهني طبقا لمثيرات واقعية على الماضي الذي يشكل الخلفية الفاعلة في مقابل نمو سردي لا يخلو من ثقل الماضي وتأمله، وتأمل نتائجه.
فالنمو السردي في هذه الرواية غير ظاهر بشكل لافت، لأنه لا يعدو أن يكون حركة ذهاب وعودة البطل من القبو الذي يقيم به بسوريا إلى مدرسة الطفل (غيث) وما يجاورها من أماكن، وذلك بعد تصفية الوجود الفلسطيني في الكويت في بداية التسعينيات من القرن الماضي. فالبطل مهموم بمراقبة الطفل لحظة دخوله إلى المدرسة وخروجه منها، واضعا في بؤرة التركيز السيارة العسكرية التي ينزل منها، وفي ظل هذه المراقبة هناك استحضار من خلال تيار الوعي لمهاتفات عديدة بين البطل وامرأة اسمها جمانة، وإشارات إلى مشابهات بين الطفل وشخص آخر.
السرد في الرواية سرد شذري يحتاج إلى تجميع من جهة أولى، ومن جهة أخرى يأتي خاضعا لتأويل البطل، حيث يتمدد السرد نحو الماضي من خلال وجهة نظره ووعيه وقناعاته، فالشخصيات في النص الروائي لا تطلّ بنفسها أو بصوتها، ولكن تطل في خطاب الحكاية في إطار تيار الوعي، وهي ارتدادات شديدة الخصوصية. ولكن آلية تيار الوعي في معظم الفصول السردية تحتاج إلى مثير أو محفز، لأن التمدد نحو الماضي لا يتولّد من فراغ، خاصة إذا كان البطل يعيش في قبو، واتصاله بالعالم يظلّ محدودا، فالاتصال يقف عند حدود الهاتف، أو السير في الطرق القريبة أو الأماكن المحيطة من مدرسة الطفل.
تأتي الآلية الثانية في النص الروائي متجاوبة مع الآلية الأولى متداخلة معها محافظة على وظائفها، بل وتؤسس للدور الذي تقوم به، بوصفها جزءا من محفزات اشتغالها، وتتمثل في قراءة الرسائل المتبادلة بين سعد الخبايا والفنانة البريطانية فانيسا ردغريف، بعد اللقاء الذي تمّ بينها وبين هؤلاء الفلسطينيين في زيارتها للكويت. والرسائل جزء لاستكمال التعرف واستمرار المساعدة، وتقدم فيها ردغريف نقدا لبعض القادة الفلسطينيين، ويتجاوب النص الروائي مع هذا التوجه النقدي.
يعتمد النص الروائي على الرسائل بوصفها محفّزا سرديا، مشيرا إلى نساء كثيرات كان لهن دور في تشكيله، من خلال العلاقات الخاصة بالبطل، مثل أم عامر، وفدوى وإقبال وأماني. والرسائل في النص الروائي لا تقوم فقط بدور المحفز بالعودة إلى الماضي، ولكنها في أحيان أخرى تمثل شهادة أو وجهة نظر معرفية، في ظلّ صراع الأيديولوجيات تجاه القضية الفلسطينية. ففي واحدة منها، تدافع ردغريف عن موقف برتراند رسل السلبي من القضية الفلسطينية، وتبريره وتكيفه في ظل سياقه الحضاري الكاره للسوفييت وللحرب النووية، ويتوافق هذا التبرير مع رأي فؤاد زكريا الذي يعرضه البطل من خلال التداعي الحر، فيتوقف – بوصفه طالب فلسفة يدرس على يديه – عند لقائه به ومناقشته لرأيه.
النص الروائي – بالرغم من اعتماده على تيار الوعي بوصفه الآلية الأكثر حضورا، وعلى الرسائل بوصفها آلية تحفظ لهذا النص تماسكه – يلحّ في نهاية كل فصل سردي على أن يعيدنا إلى الخط السردي النامي، حتى لا تتحوّل الرواية إلى استرجاعات أو ارتدادات متوالية، فيشعر المتلقي بسيولة السرد من دون حوائط حامية، وعدم تماسك خطوطه السردية. ففي هذا الفصل الذي أشرنا إلى بدايته السردية النامية في الفقرة الأولى، وتحوّله إلى ارتدادات طويلة على مدى صفحات الفصل الروائي، يختم بختام يعيدنا إلى الخط السردي النامي الذي يبدو بطيئا لانفتاحه على التأمل، حين يقول: «يتجرع ما تبقى من كأسه، أضواء السيارات المارة، تعبث بعتمة زوايا القبو، يترنّح قبل التأكد من إغلاق النافذة أعلى الجدار، يستلقي على الصوفا، رزمة الرسائل إلى جواره، يذكره سقف الغرفة بانخفاضه».
فالتعدد في الأمكنة، بالإضافة إلى الزمن الشعري المتعدد الذي يتجمع في فضاء متقاطع مع الذات في لحظة آنية، يؤشر على فكرة الشتات التي تشكل منطلقا معرفيا للرواية، بل للثلاثية الروائية على تعدد مناحيها وأشكالها، فالشتات يشير إلى مأوى زلق متقلب ارتباطا بسياقات أخرى محلية وعالمية، تسهم في إنهاء الوجود، وتعمل على تصفيته، ويتشكل وفق علاقة قلقة مملوءة بالحذر في التعامل مع بلد المأوى وأفراده، في ظل إشكاليات فكرة الوطن، على نحو ما كشف لنا النص الروائي بطريقته الخاصة في مأوى بيروت، ومأوى الكويت.
بين شتاتين وثورتين
لقد كان لتيار الوعي بالإضافة إلى الرسائل دور مهم في تشكيل الشخصيات، وفي تجلّي السرد، سواء في السرد النامي، أو في السرد القائم على الارتداد، فهناك شعور دائم بالحركة واللهاث، وهناك دائما نقصان وعدم اكتمال، فالشخصيات تعيش معاناة مستمرة، وتتحرك بوصفها شخصيات بلا ملامح كاملة واضحة، فقد اعتادت على التخفي، وهي واقفة على قدم واحدة، في استعدادها الدائم للحركة والانتقال، فالحياة – دون استحضار فكرة الوطن – مشدودة إلى ارتحال دائم، كامن داخليا، ينتظر فقط أن تحركه وتولّده الظروف والسياقات، وهذا يضع الشخصيات داخل مساحة الانفعال وليس الفعل، وإذا قامت بالفعل، ففعلها مرتبط بالتخفي، وليس على المواجهة الظاهرة.
الشخصيات في النص الروائي شبيهة بالظلال التي تتحرك في الخفاء نتيجة لفعل الانشقاق الذي تقوم به، فحركتها في معرض دائم للمراقبة، وفي انفتاح دائم للخيانات والهزائم، فكل شخصية عين على الأخرى، يكشف عن ذلك الإشارات التي يبديها الرفاق للبطل أثناء فترة وجوده بالكويت، وتلميحاتهم- خاصة تلميحات الخبايا- عن علاقته بأم عامر، في ابتعاده عن الهدف الأساسي في الارتباط بها. فالشتات الذي لا ينفصل عن الإحساس بالمطاردة يؤسس لعلاقة البطل بالعالم وجزئياته وأفراده. فالبطل يؤسس ارتباطه بالعالم في إطار الشتات والمطاردة والمراقبة، فمعاينة مكان سكنه بسوريا، والإشارة إلى (القبو)، والتلميح الدائم في جزئيات كثيرة من النص الروائي إلى رؤية أقدام المارين، كلها أشياء تظلل طبيعة الارتباط، وتجذرها في سياق من التخفي.
البطل رمز أو نموذج للشتات الفلسطيني الذي يدمغ أصحابه بالانتباه الدائم، والجاهزية للتنقل والهروب حسب متطلبات السياقات الحضارية وأرض المأوى المشدودة لارتباطات وسياقات عالمية، وليس هناك في ظل ذلك مجال لتأسيس أي ارتباط به الكثير من الديمومة والاستمرار. فسياق الشتات في إطار هذا الجيل من الفلسطينيين الذي يملك قدرة على الانشقاق عن السياق الرسمي، بل ويعريه في خطاباته ومقارباته، ويناوشه بالتنظيمات الفرعية الجانبية، يتشكل في حدود الأقبية والتخفي، تقول الرواية من خلال تيار الوعي في حركته المحدودة داخل القبو: «نتزاور في الأقبية، تتردد في أذنه عبارة رحيّم الأخيرة مع غليان الماء، يلتقط حبات البطاطس المسلوقة من الوعاء دون إغفال إلحاحه على اللجوء إلى السويد».
وقد يشدنا هذا إلى فهم خاص لعنوان الرواية «شامة سوداء أسفل العنق»، وإلى وجود رمزي لبعض الشخصيات وجدت في النص الروائي، منضوية داخل هذا التوصيف، منها شخصية جمانة أم غيث، وغادة الأسمر، وكلتاهما زوجة لضابط مهم من ضباط السلطة الرسمية، وهذا التوجيه لا يخلو من دلالة، في ظل استحضار مكان الشامة، فمع المرأتين تتموضع أسفل العنق، ومع الطفل أسفل الظهر، وفي ذلك زحزحة للظهور والوجود بشكل تدريجي من جيل إلى آخر، واستحضار شامة أخرى أسفل عنق الممثلة جين فوندا، في سياق مقارنتها بالممثلة البريطانية فانيسا ردغريف في فيلمهما معا، والأخيرة أخذت مساحة واسعة في الذهنية العربية، نظرا لموقفها المساند والداعم للقضية الفلسطينية.
السلطة الرسمية لا تكتفي بالانسلال التدريجي من الفعل الثوري المباشر، لكنها تمارس – فوق ذلك – سلوكا فيه الكثير من الاستبداد والقهر، في سياق إثبات مشروعيتها، وفي محاولتها تحويل المغايرين الذين لا يزالون مرتبطين ومتوجهين إلى الثورة في مثاليتها ومشروعية استمرارها الأبدي، بالإضافة إلى الإيمان بها، وفي قدرتها على الفعل، إلى مشابهين ينضوون داخل إطار السلطة اليابس. فالرواية – في تأملها للمتغيرات الحادثة – أشبه برصد حقيقي لحركة المقاومة في سموقها المثالي لحظة التكوين والوجود، ومرورها بانشقاقات وخيانات عديدة، وفقدانها بالتدريج للكثير من وهجها، وقدرتها على الفعل والتأثير، في ظل ارتباطها باتفاقيات شكلت لها وجودا غير قادر على إسدال مشروعية قادرة على تمثيل الانزياحات والاختلافات الأيديولوجية العديدة.
- القدس العربي